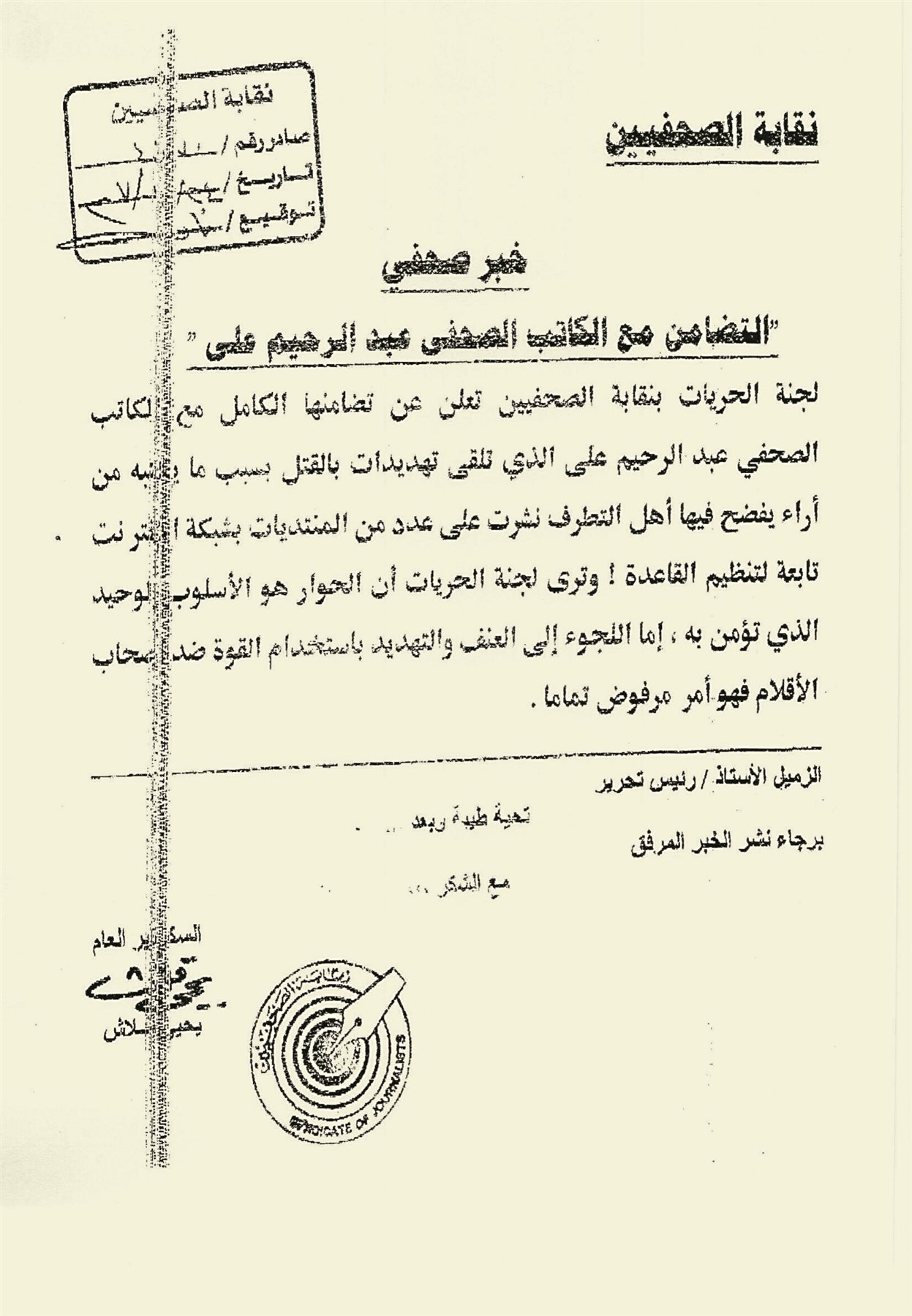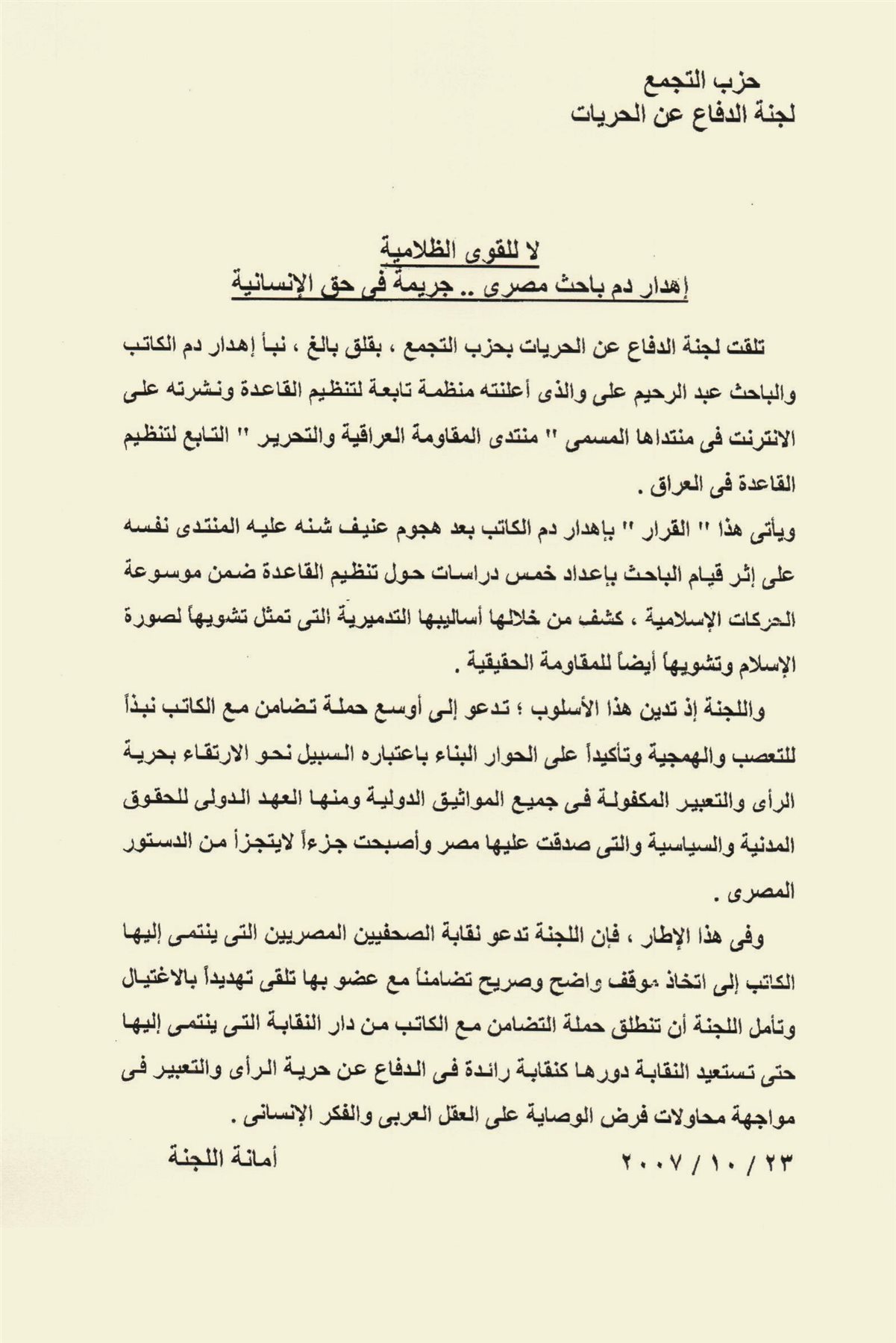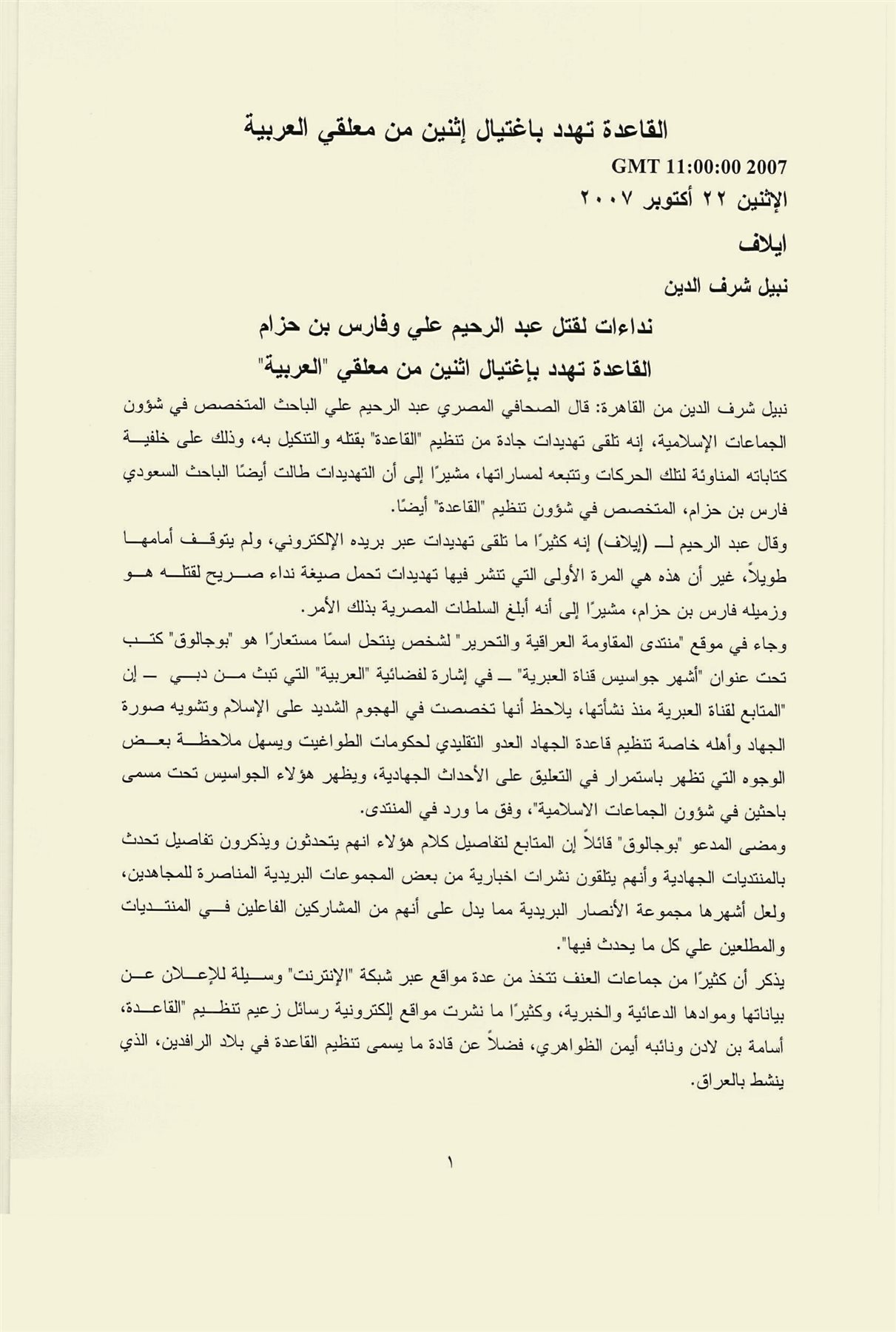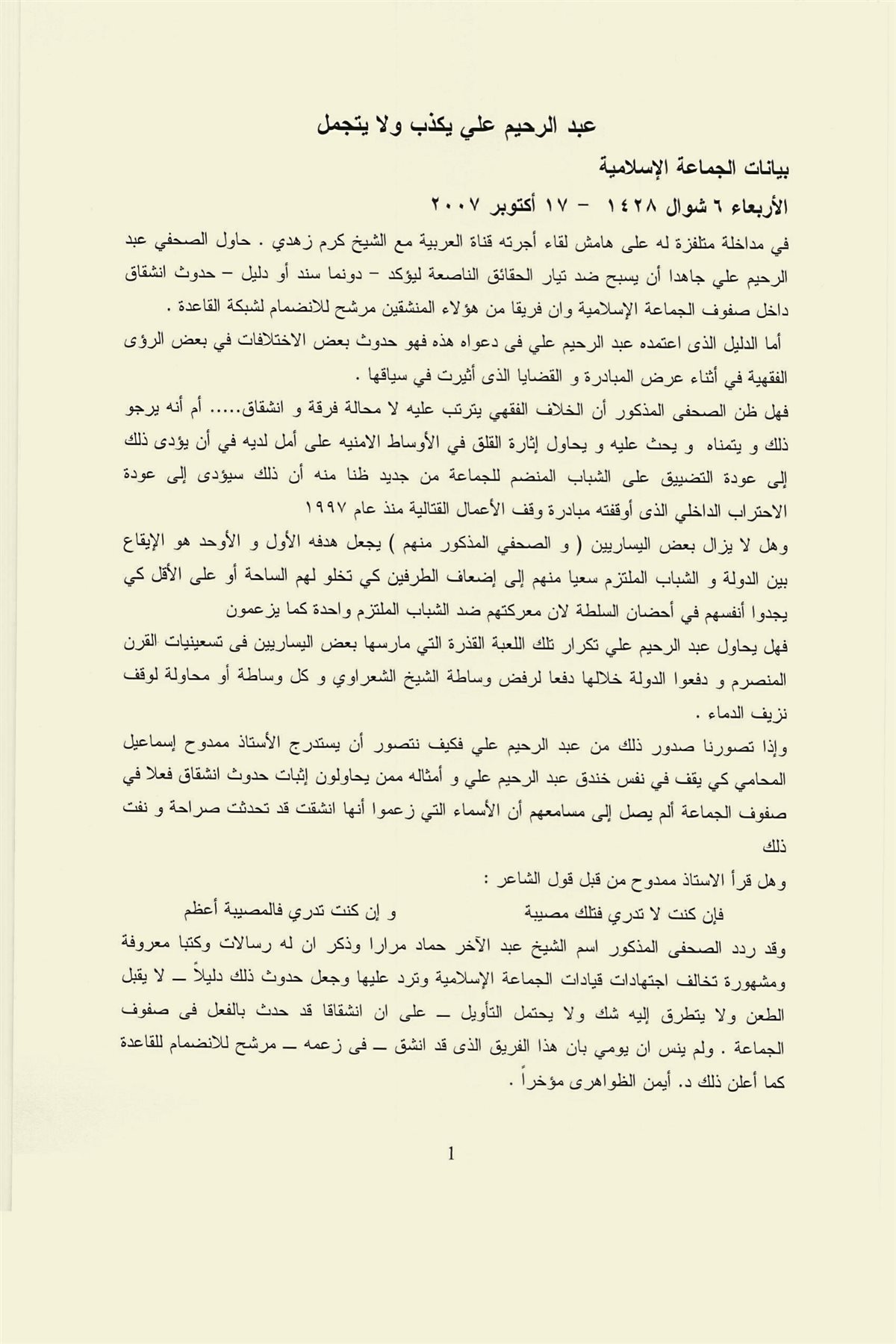من أرشيف عبد الرحيم علي
عبد الرحيم علي يكتب: في العام التاسع والخمسين.. حالة شجن

فى العام التاسع والخمسين.. لَا شَىءَ يَكْسرنِى.. وتنكسرُ الأحزانُ عَلَى أَصَابِعى.. تَنْكَسرُ المدنُ القديمةُ والذكرياتُ.. يَأتى أَبِى فِى الحُلمِ يمنحنى السّكِينةَ.. ثم يَغْشاهُ النعاسُ.. تَنامُ فى عَيْنَيّ أَحْلامِى البَعيدةِ.. ويبزغ ُمِنْ بعيدٍ، فجرُ أَيّامِى الجديدةِ..
فِى العامِ التاسعِ والخَمْسينِ.. أتذكرُ تلك الندباتِ القديمةَ.. ذَاْكَ الشجارُ.. أتذكرُ؛ كنتُ فى العاشرةِ مِنْ عُمْرِى.. حينَ شُج رَأسِى وتركتْ علامةً.. هَلْ كَانَ ذَاكَ الفتىَ أَنَا.. أَمْ أَنْهُ أحدٌ سِوَاى.. فِى العامِ المقبل.. فِى الستينِ.. رُبَما أتذكرُ كُلَ شىءٍ.. وأرسمُ فِى التَفِاصيلِ.. وَجَه بلادي..
جَنوبيٌ أنا..
أشتهِى دائمًا أنْ أكونَ الذى لم أكنهُ..
أشتهِى أنْ أُلاقى اثنتين:
الحقيقةُ والأوجهُ الغائبةُ!
هل كان كل ما مرّ بى حلمًا إذن؟ أَمْ أنهُ هوسُ الفراقِ حين تُظللهُ أشجارُ الصنوبرِ.. وبغداد تلُفها الطواحينُ التي كَفتْ عَن الدورانِ.. كَاَنَ المعلمُ يسبقنى أشعثُ الشعرِ والروحِ يلهثُ من غيرةٍ وأنا وراء لُهاثِه أرددُ:
أنا لا أنظرُ من ثقبِ البابِ إلى وطنى.. لَكِنى أنظرُ من قلبى المثقوبِ.. وأميزُ مَاْ بين الوطنِ الغالبِ.. والوطُنِ المغلُوبِ..هذا وطنٌ يا وَلدِى لم يشهدْ زورًا.. لَكِنْ شهدُوا بالزورِ عليهِ..
كانتْ تلك هِى المرّةُ الأولىُ التى التَقيه وجَهًا لِوجهِ.. عرفتهُ مِن خِلال «الاعترافِ الأَخيرِ لمالك بن الريب»، و«سفر الرُؤيا» و«سيدةُ التفاحاتِ الأربعِ»..وحفظتُ عَنْ ظَهر قلبِ أيقونتُه الرائعةِ «المعلم».. كنتُ أقارنُ دائمًا بَيْنهُ وَبَين محمود درويش، كان درويش قد وَطِئَ فى الروحِ مَوطئًا لم يطأهُ أحدٌ قَبلهُ.. وكَاَنَ هُو قَدْ حَفرَ فى قَلبى ثقبا رأيتهُ مِنهُ ورأيتُ بغداد والشيوعيين يُصّلبون عَلى حَائط البعثِ..
عالمٌ من ورقٍ.. وبَقايا نساءٍ.. وقطارٌ يمرُ يَدوسُ على واجهاتِ المُدنِ.. أرجوحةٌ مِنْ عذابٍ.. يطيشُ على إِثر تطويحها المُثقلون بِهمِّ الحقيقة.. دُون رقابٍ.. ويُرجح، مَنْ يَأكلُون على طَاولاتِ الخليفةِ.. أفئدةَ البُسطاءِ.. مِن الطبقاتِ التى زيّت أرواحَهم.. خفضةُ الجفنِ عند مُرور صبيةٍ.. تَثَنتْ.. هى الكاسُ والآس والخزُ والبدرُ.. فى جملةٍ واحدةٍ..
هذه بغدادُ العتيقةُ، وهو يجلسُ منزويًا فِى أحَد مَقاهِيها يقصُ لى تفاصيلَ رحلتهِ فِى ذلك الزمنِ البعيدِ «زمنُ الأزمةِ»، ويستفيضُ فى شَرْح التاريخِ، مُبصرًا بعينِ الحقيقةِ مَا هو آتٍ.. وكان ما كان.. فضحته السنبلة..
ثم أهدتُه النونو.. لِعُيون القتلة..
كان يوسف الصائغ يروى لى وبغداد تترى أمامى صورا من قرنفل.. كان ذلك فى الأسبوع الأول من مارس ٢٠٠٣، لا أعرف كيف نجوت بأعجوبة بعدها بأيام من الاستهداف الجوى الأمريكى لفندق الرشيد ببغداد، كان الفندق، إبانها، مقرا لإقامة الصحفيين من مختلف الجنسيات، وأسفر الاستهداف عن قتل وإصابة المئات.
لم تكن تلك هى المرة الأولى التى أفلت فيها من موت محقق.. لكننى أيقنت من يومها أننى والموت بتنا رفيقين.
كان مسرح مواجهتنا الأولى فى «المنيا» عام ١٩٩٠، عندما كمنت لى طلائع الجماعة الإسلامية بالسيوف حول منزلى يريدون رأسى.. لكن بعض الأصدقاء نبهونى فى اللحظات الأخيرة.. فارتحلت، وكانت القاهرة هى الملجأ والملاذ..
تعددت المواجهات بيننا؛ من المنيا وبغداد إلى أمستردام وباريس.. كان يحمل لى فى كل مرة مفاجأة.. وأحمل له فى كل مرة.. اليقين بالله.. يقينى بالله يقينى..
مطعم الفوكيتس
كان الجو صيفًا فى العاصمة الفرنسية باريس، وكانت قوات الأمن المصرية قد انتهت منذ أيام من فض اعتصام رابعة فى القاهرة، وكنت واحدًا من الذين طالبوا ودعموا عملية الفض.. لأن المخطط ببساطة كان خلق دولة داخل الدولة اسمها دولة رابعة.. وفى مطعم وكافيه «الفوكيتس» الشهير بشارع الشانزليزيه كنت أجلس برفقة صديق وزوجته نتناول وجبة الغداء، تحدثنا قليلا، وانصرفنا، ذهب هو وزوجته باتجاه شارع جورج الخامس وذهبت أنا باتجاه شارع الشانزليزيه، حيث كان ينتظرنى صديقى الطيب عادل سيدهم، وقبل أن أصافحه هاجمنى خمسة أشخاص وطرحونى أرضا وهم يصيحون «Assassin» بمعنى «قاتل»، وقام أحدهم بخنقى، بينما الآخرون يساعدونه فى شل حركتى، لم يكن معى سوى عادل الذى أخذ يعض بأسنانه يد الرجل التى تحيط بعنقى ويصيح طلبا للنجدة.. وفى لمح البصر سرعان ما دبت حولى أحذية الجنود الفرنسيين الذين يجوبون الشانزليزيه روحة وإيابا، ستة أفراد من رجال الشرطة الفرنسية التفوا حول الشباب الأربعة وألقوا القبض عليهم واقتادوهم إلى قسم الشرطة.. لم أعلم ماذا حدث معهم بعدها، فقد كنت فى عجلة من أمرى وكانت طائرتى ستقلع فى المساء..
أمستردام
لم تكن تلك، بالطبع، هى المرة الأخيرة فقد شهدت العاصمة الهولندية أمستردام مواجهة أخرى نجوت فيها بأعجوبة من حادث دهم لحجرتى فى «فندق جراند جرازنبولسكي» الشهير بوسط العاصمة الهولندية.. كان الصراع على أشده بين الشعب المصرى والجماعة الإرهابية، وكنت مدعوا لحضور مؤتمر وخطط البعض لاقتحام حجرتى من خلال الشرفة ولكن الله سلم، فقد خرجت قبل دقائق من اقتحامهم.
كان أحد الأصدقاء قد أصر على اصطحابى للعشاء فى أحد المطاعم التى يملكها فى وسط المدينة.. وبعد تحقيق دام لأكثر من ساعتين نقلتنى الشرطة إلى جناح فى الطابق الأول، وكانت الخسائر قليلة؛ لاب توب تخيل المقتحمون أن به أسرار الكون..
طائرة مصر للطيران
يحلو لبعض الأصدقاء تكرار السؤال: لماذا تعشق باريس إلى هذا الحد.. وهم لا يعلمون أننى أذوب عشقًا فيها، لا يرجع ذلك، كما يعتقدون، إلى شوارعها ومبانيها التى أشبه بمتحف متنقل، ولا لأنها مدينة الجن والملائكة، كما أطلق عليها عميد الأدب العربى طه حسين، لكن لأنها شهدت نجاتى أكثر من مرة من موت محقق..
فلا أنسى ذلك اليوم من شهر مايو ٢٠١٦ أظنه كان يوم ١٩، عندما فتحت تليفونى فى الصباح، لأفاجأ برقم إحدى بناتى يرن بإصرار.
كنت قد أجلت سفرى المقرر له أمس، فقدرت أنها قلقة لذلك، لكن ما إن سمعت صوتى حتى أجهشت بالبكاء؛ خلت أن شيئا كبيرا قد حدث لأسرتى فى القاهرة، لكنها سرعان ما بادرتنى بقولها، حمدالله ع السلامة، قلت لها أنا ما زلت فى باريس، قالت بصوت محشرج: لقد سقطت الطائرة التى كان من المفترض أن تستقلها أمس فى المحيط، أصبت بصدمة، لم أستوعب الخبر للحظة، داهمتنى صور عديدة، فخوفى على بناتى لم يفارقنى لحظة منذ أن رزقت بغادة قبل أربعين عاما حتى الآن، كنت قد بلغت العشرين آنذاك، وكانت غادة ابنتى البكر.. لم أصدق حينها أننى أصبحت أبا..
خلتها بيدى لعبتى وصديقتى ومعشوقتى ولم تزل.. حتى بعد أن أصبحت أمًا لثلاثة أطفال أكبرهم الآن فى الرابعة عشرة من عمرة.. كنت أخاف عليها من النسيم إذا داعب شعرها وأغار عليها حتى من أمها.. وانتقل هذا المرض من بعدها لكل شقيقاتها.. ربما اختلف هذا الإحساس قليلا مع خالد، فقد ربانى والدى بشكل مختلف حاولت أن أكرره مع ابنى الوحيد، لكننى أعترف بأننى قد فشلت، فحولته من ابن لصديق ولم يزل هو الصديق الأقرب إلى قلبى وعقلى معًا.. توالت الصور أمام عينى ماذا كان سيحدث لهم بعدى ومن يربت على أكتافهم، يحتضنهم، يكفف دموعهم يمنحهم الدفء والأمان؟..
سرعان ما عدت إلى غادة أسألها وأنا أقلب فى تليفونى لأجد عشرات الاتصالات الفائتة ومئات رسائل الاطمئنان.. كيف حدث ذلك؟ لكنها بادرتنى بالسؤال كيف تخلفت عن ركوب الطائرة كما كان مقررًا؟
وتذكرت وأنا أسرح فى سؤالها كيف استفزنى موظف الريسبشن فى فندق «كلاريدج» الواقع بشارع ماربوف الشهير بباريس، ذلك الشارع الذى حج إليه قامات من كبار الكتاب والأدباء المصريين والفرنسيين قاصدين مكتب الأهرام فى باريس إبان مجده.. كنت قد قدمت من بروكسل قبلها بيومين وقضيت ليلتين فى الفندق وفوجئت به يوقظنى أمس الساعة الثانية عشرة ظهرًا ليخبرنى بأن موعد المغادرة قد حان، وأردف معتذرًا بأن الفندق ممتلئ عن آخره نظرًا لاستضافة فرنسا كأس الأمم الأوروبية، ولأننى كائن ليلى، لا أنام إلا بعد الفجر فقد انفجرت غاضبًا فى وجه الرجل.. قلت له كيف أخرج من غرفتى وطائرتى فى الحادية عشرة مساء؟ ورد ببرود: تلك هى القواعد! ووجدتنى أقول له بانفعال: إذن فلتمدد لى ليلة أخرى وأغلقت باب غرفتى على الفور.. نمت قليلًا ثم قمت من نومى وأعددت نفسى للخروج حيث اصطحبنى أحد الأصدقاء للتسكع قليلًا فى الحى اللاتينى، عرجنا قليلًا على نهر السين، ثم تناولنا عشاءنا فى مطعم «البروكوب» الشهير (أول مطعم نشأ فى باريس بعد الثورة عام ١٧٨٩)، وبعدها عدت إلى الفندق متأخرًا.. فنسيت أن أخبر الشركة بتعديل التذكرة للغد ونمت وفى الصباح كان ما كان.
مستشفى كريملن بيستر
لا أعرف لماذا تلح عليَّ تلك الذكريات البعيدة والقريبة فى هذا التوقيت.. ربما لأننى أبلغ اليوم التاسعة والخمسين من عمرى وأدخل عامى الستين وأنا ممتلئ يقينا بأن ما يريده الله كان.. أو ربما لأننى أنظر الآن فى بلورة العمر وأبصر ما تبقى من دمى.. فما تبقى يكفى، ربما، لكى أعشق عشرين امرأة.. وثلاثين مدينة.. ربما لأدخل جسم السوسنة وأصير قصيدة.. ربما لأكشف عن بعض ضعفى أمام المرايا، فقد خفت كثيرًا تلك المرة التى انتزعوا فيها تليفونى على أبواب مستشفى (Kremlin Bicetre) «كريملن بيستر» التعليمى فى باريس بعد إصابتى الخطيرة بفيروس كورونا فى الثامن عشر من يونيو ٢٠٢٠.. أخذونى مباشرة من سيارة الإسعاف إلى إحدى غرف العناية المركزة وعلقوا لى أجهزة الأوكسجين، كنت وقتها بين الحياة والموت.. كان الرعب ينتابنى، فربما لن أستطيع توديع عائلتى بعد اليوم، ربما أيضًا لن أستطيع مساعدتهم، خاصة وقد نقلت ابنتى الكبرى غادة وزوجها، وزوجتى وأم أولادى، إلى العناية المركزة بمستشفى قصر العينى، فى نفس التوقيت تقريبًا.
كان اختبارًا صعبًا لصلابة تلك العائلة الصغيرة، التى كانت نعم العون لى فى كل مراحل حياتى.. كان جزءًا من قدرى أن أفعل شيئًا ما حتى وإن كنت أحتضر.. وسرعان ما وجدت نفسى أزيل كل الخراطيم المعلقة بجسدى، حاولت مجتهدًا وأنا ألتقط أنفاسى بصعوبة أن أصل إلى الحقيبة الخاصة بحاجياتى التى كانوا قد وضعوها فى خزانة بالقرب من سريرى، والتقطت الهاتف ووضعته مباشرة على خاصية «الصامت» وعدت إلى سريرى أعدت الخراطيم مكانها بعناية.. وبدأت أرسل الرسالة تلو الأخرى، كانت رسالتى الأولى إلى ابنتى غادة، حيث اطمأننت عليها وعلى زوجها ووالدتها، ثم أرسلت رسالة أخرى أوصيت فيها بعض الأصدقاء على عائلتى خيرًا.. والحق يقال؛ كثيرون كانوا كرامًا فى تلك المحنة، ليس فقط فى مصر، ولكن خارج مصر أيضًا، كثيرون عرضوا نقلى وأسرتى للعلاج لديهم، لكن النصائح كلها كانت أن أبقى فى باريس، وتبقى العائلة فى قصر العينى.. كثيرون سوف أظل ممتنًا لهم ما حييت لمساعدتهم فى إنقاذ ابنتى وزوجها، وزوجتى وأم أولادى من موت محقق.
كان الاتصال الثالث بخالد ابنى فى برشلونة حيث كان بصحبتى فى الطائرة التى أقلتنا إلى باريس، افترقنا فى مطار شارل ديجول وذهب هو إلى مقر جامعته فى برشلونة؛ حيث لم يسمح له بدخول باريس وفقًا لقواعد الحجر الصحى آنذاك لأن إقامته كانت على إسبانيا، ظننت أنه ربما يكون قد أصابه الفيروس اللعين، وبعد محاولات مضنية استطعت أن أحصل له على موعد فحص بأحد مستشفيات برشلونة بمساعدة بعض الأصدقاء هناك.. حيث كان من الصعوبة بمكان، فى تلك الأيام، أن تحصل على موعد فحص قبل أسابيع.. والحمد لله جاءت النتيجة سلبية.
لن أنسى ذلك اليوم الذى دخل الأطباء عليّ فى غرفة العناية المركزة ليخبرونى بضرورة أن أوقع لهم على إقرار بالموافقة على وضعى على أجهزة التنفس الاصطناعى، وهو ما يعنى دخولى فى غيبوبة لمدة قد تطول أو تقصر حسب الحالة..
لكننى رفضت على الفور، قلت لهم لن أغيب دقيقة واحدة عن الوعى وأسرتى على هذه الحال.. سأقاتل هذا الفيروس اللعين وسأموت وأنا فى كامل وعيى، فاقترح عليّ كبيرهم طريقة معينة للتنفس باستخدام أنابيب الأوكسجين دون الوصول لمرحلة الغيبوبة، فكنت أنام ١٢ ساعة فى اليوم بشكل معين يسمح للرئتين بالامتلاء نسبيا بالأوكسجين، ونجحت تلك الطريقة واستطعت بفضل دعوات أمى وأسرتى والمئات من الطيبين الذين كانوا يدعون لى ليل نهار، من اجتياز مرحلة الخطر بعد عشرة أيام قضيتها فى العناية المركزة على هذه الوضعية، وحيدًا استقبل الرسائل من الجميع وأرد دون أن أنطق بحرف واحد ودون أن يكتشف الأطباء المعالجين أننى أخبئ الموبايل تحت مرتبة السرير.
كرم الله
لقد أكرمنى الله ونجوت عشرات المرات من موت محقق.. ومنحنى حياة جديدة خمس مرات على الأقل، ربما لأعرف أن الحياة منحة كبيرة وجميلة من الخالق يجب أن نستغلها فى إشاعة قيم الحب والخير والجمال، وأن ندفئ بعضنا بعضا وأن نحنو على بعضنا البعض بأقصى ما نستطيع؛ لأننا سرعان ما سوف نغادر ولن يبقى سوى الأثر، فليكن كما المسك كلما حل أو ارتحل ترك أثرًا جميلًا فى نفوس الجميع.. وها أنا ذا فى عامى التاسع والخمسين.. أقر أنا المذكور أعلاه؛ بأننى لا أحمل ضغينة تجاه أحد ولا أحقد على أحد ولا أحسد أحدًا وأتمنى لو استطعت أن أضم العالم كله بين جنبات قلبى وأمنحه من الحب والسعادة ما أستطيع.. أخطو نحو الستين ولا شىء يملك علىَّ شغاف قلبى سوى عائلتى وأحبائى وأصدقائى.. وبلادى.. مصر..
مصرُ التلات أحرف اللى مالية الدنيا ضجيجَ
بحبها وهيَ مالكةُ الأرضِ شرقَ وغربَ
بحبها وهيَ مرميةٌ جريحةُ حربٍ
بحبها برقةٍ وعنفٍ وعلىَ استحياءٍ
وأكرهُهَا وألعنُ أبوهَا بعشقٍ زى الداءِ
وأهربُ فى دربِ وتبقىَ هيَ فى دربٍ
وتلتفتْ تلاقينى جنبها فيِ الكربِ.